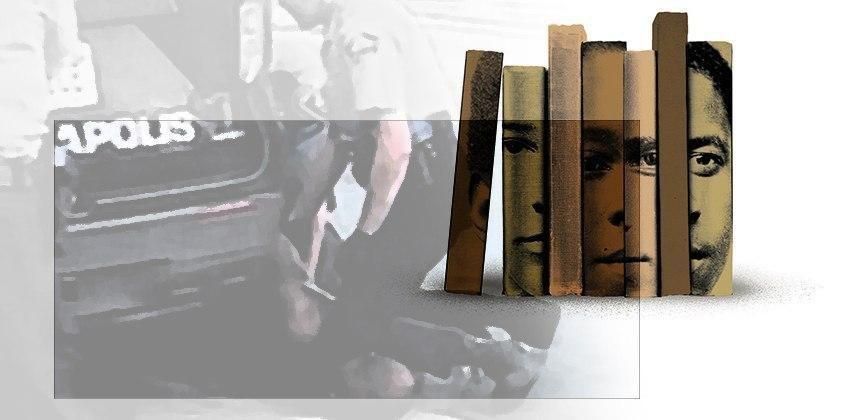
باسمه تعالى
الرواية الغربيّة و"إشاقة"[1] العنصريّة اختلاقًا وترسيخًا
د.زينب الطحان
كتب "جورج أورويل"[2]، الروائي البريطاني الشهير، أنّ أحدَ أهمّ دوافع كتابة الأدب هو الرغبة في تغيير أفكار المجتمعات، ودفع العالم صوب اتجاه بعينه، كما: "يُكتب الأدب أيضًا من أجل نشر الأفكار، سواءً كانت سياسيّة أم اجتماعيّة. ولأنّ مناخ الحريّة يسمح للجميع بعرض أفكاره ونشر كتاباته، فإنّ الساحة الأدبيّة الأوروبيّة تعجّ بأدباء اليمين المتطرّف مثل: شارل موراس وبيار در ودولاروشال وفريديناند سيلين"[3].
نوافق تمامًا على دور الأدب هذا، وهي وظيفة معرفيّة تنتجها المجتمعات الإنسانيّة، بشكل تلقائي، كونها وسيلةً جميلة وإبداعية للتعبير عن حضارته وانتاجاته الثقافيّة والفكريّة وفلسفته التي تحكم حياته. من هنا أيضًا، نرى أنّ طروحات "أدباء اليمين المتطرّف"، والذين أشار إليهم الروائي "أورويل"، تستغلّ هذه الوظيفة لترسيخ رؤى مختلفة تمامًا عن المسار الطبيعي للأدب، على مدى التاريخ الإنساني. فإذا وافقتَ، عزيزي القارئ، مع "أورويل" في تعريفه للأدب، من خلال إظهار وظيفته المعرفيّة، تجد أنك تتفق طوعًا مع جوهر تعريف الأدب الذي يقدّمه الإمام السيد علي الخامنئي[4]، حين يقول:"الشعر والأدب يحفظان الهويّة الوطنيّة للشعوب وخصائصها ومزاياها الثقافيّة؛ فهذه الهويّة الثقافيّة هي الأصل"[5].
إذا كان للأدب هذا الدور الخطير في مسار الإنسانيّة، فلماذا يا تُرى نرى هناك من يعزله عن ما يعكسه كاتبوه من خلفيات عقديّة (إيدولوجيّة) وثقافيّة، ويسوغّون لمقولة "الأدب من أجل الأدب"، على غرار "الفن من أجل الفن"؟ لقد أثبتت مختلف التجارب الإنسانية أنّ مفهوم الحياد هذا لا وجود له مطلقًا في تاريخ أي أمّة كانت. وهذا ما يكشفه لنا عمق التحليل الثقافي للأدب المقارن الذي أبدعه المفكر الفلسطيني- الأميركي الراحل "إدوارد سعيد"[6]، حين يثبّت في كتابه "الثقافة والإمبرياليّة" أنّ: "معظم محترفي العلوم الإنسانيّة عاجزون عن أن يعقدوا الصلة بين الفظاظة المديدة الآثيمة لممارساتٍ مثل الرقّ والاضطهاد الاستعماري والعنصري، والإخضاع الإمبريالي من جهة، وبين الشعر والرواية والفلسفة التي ينتجها المجتمع الذي يقوم بمثل هذه الممارسات، من جهة أخرى. إنّ إحدى الحقائق التي اكتشفتُها في أثناء إعدادي لهذا الكتاب هي ندرة الفنانين والأدباء البريطانيين، ممن أُعجب بهم، والذين اعترضوا على مفهوميّ الأعراق الخاضعة والأدنى مكانةً مما ساد بين الموظفين الذين طبقّوا هذه المفاهيم كمسألة بديهيّة في حكمهم للهند أو الجزائر. لقد لاقت هذه المفاهيم قبولًا واسعًا، وقدّمت الوقود للاستيلاء الإمبريالي على الأراضي في أفريقيا عبر القرن التاسع عشر بأكمله"[7].
يؤكد "سعيد"، في كتابه هذا، والذي شرّح عدة روايات غربيّة ونَقَدَها، على أنّ فنون الأدب، والرواية تحديدًا، حتمًا تعكس رؤى كاتبيها ومنتجيها وتصوّراتهم الفكريّة والثقافيّة، وبما أنّ أدباء القرن التاسع عشر في أوروبا، بلد الاستعمار التاريخي، يؤمنون بتفوّق عرقهم "الأبيض الأوروبي" على بقية شعوب العالم، رأينا كيف مجّدوا ثقافة هذا العرق العنصري روائيَا، وأسّسوا له أعمدة بنيويّة فلسفيّة تفصل بين "الأبيض" وغير "الأبيض"، بوصف هذا الفصل "أسطورة" من أساطير الإميرياليّة ذاتها. والإمبرياليّة هي بيئة ثقافية تأسست بفعل تجمّع الطبقة البرجوازية في المجتمعات الأوروربيّة، حتى قبل احتلالهم لبلد الهنود الحمر (الولايات المتحدة الأميركيّة)، فقد رسّخت فلسفة العنصرية – الكراهية موقفًا ذهنيًا فكريًا، ما لبث أن أصبح سلوكًا اجتماعيًا، ومطبقًا بوسائل عنفيّة ودمويّة، في أغلب الأحيان.
بذور هذه الفلسفة تراها بوضوح في كتابات بعض الفلاسفة الأوروبيين، والذين بنوا اعتقادهم على أنّ الحياة مبنيّةٌ على تعارض الأجناس البشرية، أي صراع بين البشر "المتحضّرين" ضد البشر "المتخلّفين"، وعلى قاعدة حتميّة التخلّف البنيوي لجميع الثقافات الأخرى غير الأوروبيّة، ما وفّر البيئة الاجتماعيّة والثقافيّة لظهور النزعات العنصريّة والأفكار اليمينيّة المتشدّدة لاحقًا في أوروبا، مثل النازية والفاشية والصهيونية، وأحدث فكرًا قوميًا شوفينيًا، تسبّب بقيام نزاعات إقليميّة وأشعل حروبًا عالمية. فالفيلسوف الألماني "إيمانويل كانت"، على سبيل المثال لا الحصر، رغم كونه أضاف للفكر الإنساني الكثير مع "نظرية المعرفة"، إلا أنّه واحد من أهم المفكّرين الذين دعوا إلى تصنيف الأجناس البشريّة بحسب المعايير العرقيّة، بشكل مستفزّ. فرأى أن أصحاب البشرة البيضاء هم أكثر الأنواع البشريّة ذكاءً وفاعليّة ومقدرة على بناء الحضارات، ثم يأتي أصحاب اللون الأصفر في الدرجة الثانية، في الدرجة الثالثة يأتي أصحاب البشرة السوداء، ومن خلفهم بقية الأجناس الأخرى، وفي الأسفل الهنود الحمر الذين صنّفهم أسوأ الأجناس وأقلّهم تطورًا وذكاءً. فيما رأى صاحب كتاب "دراسة حول التفاوت بين أعراق البشر"، المفكر الفرنسي المعاصر "آرثر دي كوبينو"، أنّ اختلاط الأعراق وتزاوجها هو سبب انحطاط الحضارات وسقوطها، ويؤكد أنّ القضية العرقيّة هي صانعة التاريخ، فذكر أن "الآريّة" تنحدر حين تختلط بالفنون الزنجية، وهي الأفكار التي ألهمت الرئيس الألماني "أدولف هتلر" لاحقًا، وأصدر بسببها قانون التعقيم وتحديد النسل في العام 1933.
من هنا، يربط المفكر والناقد "إدوارد سعيد" بين ما قدّمته الرواية الغربيّة (الأوروبيّة تحديدًا، وفي القرن التاسع عشر، وهي المرحلة الكبرى في تطوّر أدب هذه الرواية) وبين تلك الأفكار والرؤى الفلسفية والتصنيفات العنصريّة التي روّج لها معظم بُناة الفلسفة الغربيّة، والتي للمفارقة يصفونها بـ"التنويرية". لذا، لا تجد بدًّا، عزيزي القارئ، من ربط هذا الفن الأدبي الغربي بتطوّر الطبقة البرجوازية ونشأة النظام الرأسمالي، وتمجيد قيمها وسبغ النبالة والرفعة الإنسانيّة عليها، على أنّها الثقافة الوحيدة التي تصنع للإنسان حضارته وتقدّمه، بينما هي أداة ووسيلة غادرة في تزوير الحقائق وتشويه التأريخ الإنساني، وكيّ الوعي المقاوم للاستعمار والإمبرياليّة. فلا ريب أن تجد كلّ هذه المنظومة الفلسفيّة وما تروّجه لها الرواية تنتقل مع هؤلاء الأوروبيين إلى العالم الجديد (أميركا) الذي احتلوه بعدما أبادوا شعبه. إنّ الأدب، حين يُصوّر بهذا الشكل الثقافي، ينتج وعيًا زائفًا، يؤسّس لمنظومة تربويّة تنشأ عليها الأجيال، من هنا المتتّبع للأدب الغربي، على وجه أخصّ الرواية منه، يُلاحظ مدى توغّل هذا الأدب بروح عنصريّة وكراهيّة شديدة من الأبيض الأوروبي والأميركي تجاه الآخر، أيًا كان هذا الآخر، أسودَ (زنجيًا)، آسيويًا، مشرقيًا، عربيًا، إسلاميًا .. إذ يسود في الرواية الغربيّة، عند معظم كتّابها – كما أشار إدوارد سعيد- هذا الاستعلاء العنصري.
انسحبت هذه الهويّة السرديّة على مدى أجيال متعاقبة، حتى باتت جزءًا مكوّنًا من الثقافة الغربيّة، ومعلمًا أساسيًا عند معظم منتجيها من مفكّرين ومثقفين وفلاسفة، والذين عمدوا إلى إقناع الآخر أنّه عاجز فطريًا أمام التفوق البيولوجي (التركيبة الإلهيّة) للأوروبي، لذا، لا بدّ أن يُترك له زمام الأمور من سيطرة وهيمنة وإدارة وتحكّم بشؤون العالم وشعوبه. وعندما أثبت العلم الحديث أنّ لا حقيقة وجوديّة لهذه "الأسطورة" تقدّموا بادعاء آخر يقول بأصالة الانتماء الحضاري الحديث بين الأمم على مدى مساحة الكرة الأرضيّة، ضاربين عرض الحقيقة المؤكدة لوجود حضارات مختلفة من أمم عديدة، سبق وعمّرت الأرض وعاشت حقبات من الازدهار الحضاري الراقي إنسانيًا وعلميًا بمعيار النقد الموضوعي المعاصر.
الدراسات الأكاديمية، في تحليل رواية الأدب الغربي، وخصوصًا في القرن التاسع عشر، مرحلة "ازدهار الاستعمار"، والتي فتح بابها واسعًا الراحل "إدوارد سعيد"، تبيّن برؤية متقدة وطباقيّة وتحليل دقيق للاستخطاطيات (الاستراتيجيات) الإمبريالية كيف أنّ كتّاب هذه الرواية – عند الأغلب من جيل الروائيين في القرنين التاسع عشر والعشرين- عمدوا إلى مأسسة "إشاقة" ثقافية عميقة تحفر في الوعي الغربي سلخ الإنسانيّة عن غير الأوروبيين، وتُبرز شعوبًا وأصقاعًا بأسرها خاضعة ودونيّة، وتُظهرها متوافقة وحكم الهيمنة راضية بإذلالها واحتقارها من "سيدها الأوروبي" أو "سيدها الأميركي"!..
يحكي الكاتب "رالف أليسون" (Ralph Ellison)في روايته "الرجل الخفي"، في العام 1952، عن تجربته بصفته أميركيًا من أصل أفريقي، على لسان بطل الرواية -لم يذكر اسمه عمدًا للدلالة المعرفيّة- يعيش في قبو منسي، في مكان ما في نيويورك، معزول عن الأنظار، فيقول: "أنا إنسان من دم ولحم وعظم وألياف وسوائل… ولديّ عقل على ما يدّعي بعضهم… لكنّني غير مرئي… إنهم لا يرونني، لأنّهم ببساطة يرفضون رؤيتي". إنّ المأزق الذي تشير إليه هذه الشخصية (موجود، ولكنّني غير مرئي) يتردّد صداها إلى اليوم، وليس هناك دليل أبلغ على ذلك من مقتل المواطن الأميركي (الأسود) "جورج فلويد" على يد شرطي أبيض لم يستجب لاستغاثاته، في أيار الماضي من هذا العام. وفي هذا دلالة وإشارة قويّة إلى مدى فاعليّة الهويّة السرديّة الغربيّة في بناء صرح فكري- ثقافي "تتأصل" فيه رؤية "استحقار الآخر"، والتي لم تنشأ إلا بفعل الروح الاستعماريّة التي سيطرت على ملوك العالم الغربي القديم باحتلال أراضي جيرانهم، وحتى البعيدة عنهم في قارات أخرى، والذين أسّسوا لطبقة من الأدباء كي يُلبسوا وجه استعمارهم الوحشي وجهًا ثقافيًا بصبغة جماليّة فنيّة، تجعل القارئ الأوروبي يستمتع ويتشرّب تلك الروح العنصريّة ممّا يقرأه ويرسخ في ذاكرته.
تأسيسًا على ذلك، تتنج عملية الاستقراء الأدبي للرواية الغربيّة، والتي هي بطبيعة الحال مترجمّة إلى كلّ لغات العالم، علاقة تداوليّة بينها وبين الواقع من جهة، وبينها وبين القارئ الفاعل من جهة أخرى. فالقارئ المتلقّي، يستقبل ما تقرأه عيناه بوعي متحفّز إمّا للموافقة والرضى، وإمّا للنقد والهدم والتفكيك وإعادة البناء، وهذا لا يحدث غالبًا إلا حين يكون هذا المتلقّي شخصًا مثقفًا أو مطّلعًا، في الحدّ الأدنى، بغض النظر عن تفاوت مستواه الثقافي واطلاعه. وبهذا تتكوّن حلقة الوصل بين النصّ السردي الروائي، والعلامات المجازيّة للخطاب الثقافي المرتبط بأفاق الثقافة السابحة في الفضاء العام، لأي مجتمع. ولهذا السبب لا يمكن قراءة أي رواية إلا من حيث صلتها بالحاضر القرائي واختلافها عنه، فهذه الصلة هي التي توفّر أرضيّة جدليّة وحواريّة يّعرف من خلالها المعنى العام للرواية، والهدف الأوحد للمؤلف، والذرائع البراغماتية التي يمكن أن يسوقها لقراءة مثل هذه الأعمال الاستعادية. ولأنّ النقاش المثمر ينبغي أن يتمحور حول الأثر الدلالي للرواية، وليس حول الأثر الشكلي المحسوم، فالأثر الدلالي بحكم تعريفه وتأثيره لدى القراء المعاصرين، لا يمكن تشخيصه على أنّه تركيب ثقافي اعتباطي، فلا بدّ له أن يرتهن للسائدية الراهنة، وأن يؤتى به إلى دائرة اهتمام القارئ وترجيعات قلقه وصداعه وتوجساته، ورؤاه الثقافيّة.
الرواية، بهذا المعنى، هي تمثّل "الهويّة الوطنيّة للشعوب وخصائصها ومزاياها الثقافيّة"، التعريف الذي أدلى به الإمام الخامنئي، فهي بحكم الاستحالة ألا تعكس رؤى كاتب ما والفلسفة التي يؤمن بها، ما دام ينتمي إلى وطن وأمة تملك هويّة محدّدة تميّزها عن غيرها من بقية الأمم، فـ"الهويّة الثقافيّة هي الأصل"، وهي التي تشتغل في توجيه القيم وترسيخها، دعمًا وتركيبًا، وهذا تحديدًا ما قام بالبرهنة عليه "إدوارد سعيد" في كتابه "الثقافة والإمبرياليّة". ففي حين عمل، ويعمل، معظم أدباء العالم الغربي في تعضيد وعي الذات بـ"قيم"[8] العنصريّة تجاه الآخر، والمساهمة في إضمار مفاهيم القيم الإنسانيّة النبيلة، ترى صورة ثقافية أخرى في إنضاج وعي الذات بمعناه الإنساني المعرفي لتعمير الأرض والتقاء الثقافات، من هنا يقول الإمام الخامنئي :"ومن جملة المهام التي يركّز عليها المسؤولون الثقافيون في الحكومة بكل دقة؛ وألا يضيعوا حتى دقيقة واحدة بخصوصها؛ هي أن يمنحوا لثقافة المجتمع العامة الأدوات والوسائل الثقافية المنتشرة اتجاهاً قيميًّا. لقد بُذلت جهود كبيرة لأجل توجيه التيارات والعوامل الثقافيّة – الفن والأدب والشعر والسينما وغير ذلك- باتجاه غير قيمي. واجبكم هو السعي الدؤوب لإضفاء طابع قيمي على العمليّة الثقافيّة في البلاد"[9].
في هذا التوجيه القيمي، والذي يربط بين مفهوم القيم وإنتاج الأدب، يرسم الإمام الخامنئي أسسًا واضحة حول بناء أنموذج حضاري راقٍ، وواحدة من مكوّناته التي لا غنى عنها هي الأدب، ويقصد به الأدب الفاعل في صناعة تلك الهويّة الثقافيّة للذات الوطنيّة، وتبني لها جسرًا للالتقاء مع الآخر، لا للتخاصم معه أو نفيه أو اضطهاده أو حرمانه من صوته ولونه. وهذا التصادم هو روح الفلسفة الغربيّة المعاصرة، والتي تمثّلت برؤى "صموئيل هنتغتون"[10]، فإذ هي استكمالٌ لتلك الفلسفة وترسيخٌ لمقولة "العنصريّة"، في حين أنّ الفطرة الإنسانيّة تقود الجماعات البشريّة نحو ضرورة التواصل والتفاعل والإثراء المتبادل بين الثقافات - }يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{[11]- والصراع ضد الهيمنة والاستعمار والاحتلال.
لم يعد مستغربًا، عزيزي القارئ، بعد كلّ ما تقدّم أن تعرف أنّ نشوء الرواية الغربيّة ملازمٌ لظهور الإمبرياليّة والاستعمار، وهذا ما أثبتته دراسات "إدوارد سعيد"، فهو يربط بين تجاوز الفضاء الجغرافي وبين الرواية وبين حركة التوسّع الإمبراطوري وبين ازدهار الرواية، لا ربطًا أليًا جامدًا، بل ربطًا حيويًا وخلاّقًا، يجلو كيف تتجسّد الوشائج في بنية الرواية ذاتها وأليات تشكيلها. فقراءته مثلًا للروائي الفرنسي "ألبير كامو" (1913- 1960) بعدما يسلخ عنه سحر اللغة الأدبيّة، وسحر ما لفعه به القارئ الغربي من "ولع بالشرط الإنساني"، يكشف أنّ جوهر أدب "كامو" هو الدفاع عن الإمبرياليّة الفرنسيّة وإلغاء التاريخ الجزائري السابق على استعمار فرنسا، وهو يفسّر المكوّنات الأساسية لأعمال "كامو" في إطار إشكاليات معرفيّة مرتبطة بمنظوره الإمبريالي[12].
في المقابل، ترى ما يكتبه الغربي أو الأوروبي، من أصل أفريقي أو آسيوي، من أدبٍ يتجلّى بكشف اللثام عن مكمن تلك الروح العنصريّة، بعد فكفكة الاستعمار بعد الحرب العالميّة الثانية، وما تجرّه على الشعوب والعالم والأفراد، بدرجة أولى، من أزمات وكوارث بشريّة، واستغلال فظيع لموارد أرضه وإنسانيته، خصوصًا بعدما ثبتّت النيوليبراليّة (الرأسماليّة الجديدة) أرضيتها في التحكّم بمصائر الشعوب. شكّل هذا الإنتاج الأدبي عند هؤلاء الذين كانوا موضوعًا لعلم الإنسان (الإنثروبولوجيا) الغربي والسرديات الغربية والنظريات التاريخيّة، و"كانوا في النصوص الثقافيّة الدليلَ السلبي على شتّى أنواع الأفكار حول الشعوب غير الأوروبيّة الأقلّ تطورًا، والتي ظلّت جواهرها ثابتة عبر التاريخ، خلاّقين لآدابهم وتواريخهم الخاصة، كما يصبحون أيضًا قرّاءً ناقدين لسجل المحفوظات الغربي"[13]. ولقد نال عدد منهم جوائز عالميّة تشهد لهم بالإبداع الأدبيّ، والتزامهم بقضايا جنسهم، والدفاع عنها، وهذا هو الغالب الذي يتسق مع الإنسانيّة والحسّ السليم.
[1] - أشاق – إشاقة /أشاقه : وجده شائقًا مستحبًا ( معجم الرائد).
[2] - "جورج أورويل" هو الاسم المستعار لـ"إريك آرثر بلير" (1903-1950- Eric Arthur Blair)، أشتهر بعمله الديستوبي "رواية 1984" التي كتبها في العام 1949، وهو يعدّ في المرتبة الثانية في قائمة "أعظم 50 كاتبًا بريطانيًا منذ العام 1945".
[3] - أسماء رمضان، الأدب العنصري: كيف نجح اليمين المتطرّف في الفوز بالمعركة الثقافية؟، موقع "نون بوست" الإلكتروني، صفحة فن وأدب، 20/3/2019.
[4] - السيد علي الحسيني الخامنئي (1939) هو قائد الثورة الإسلاميّة في إيران، والولي الفقيه الذي استلم زمام قيادة البلاد بعد وفاة مفجّر الثورة الإيرانية الإمام الخميني الراحل. وكان الرئيس الثالث للجمهورية الإسلامية من سنة 1981 إلى 1989. وكان قد اعتقل ست مرات؛ قبل منفاه، لمدة ثلاث سنوات في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. في العام 2012، اختارته مجلة "فوريس" في قائمة 19 شخصية مؤثرة (أكثر نفوذًا) في العالم.
[5] - السيد علي الحسيني الخامنئي، عناصر الثقافة، ترجمة عباس نور الدين، معهد المعارف الحكميّة، 2017، ص 39.
[6] - إدوارد وديع سعيد (1935 -2003) كان أستاذًا جامعيًا للنقد الأدبي والأدب المقارن في جامعة كولومبيا في نيويورك، ومن المؤسسين لدراسات ما بعد الاستعماريّة (ما بعد الكولونياليّة) وفي النقد الأدبي الحضاري ومدافعًا عن الشعب الفلسطيني، وهو صاحب كتاب "الاستشراق" (1978)، والذي بيّن فيه ارتباط الدراسات الاستشراقيّة بالمجتمعات الإمبريالية، فشكّل كتابه هذا منعطفًا في تاريخ الاستشراق، وأثار ضده هجمات شرسة من معظم المفكّرين والمثقفين في أوروبا، وجلّهم من اليهود الصهاينة أو المتصهّينين.
[7] - إدوارد سعيد، الثقافة والإمبرياليّة، ترجمة كمال أبو ديب، الطبعة الرابعة، العام 2014، دار الآداب، ص 59.
[8] - تُعرّف القيم الإنسانيّة على أنّها الفضائل التي تُوجّه الإنسان إلى مُراعاة العنصر البشري عندما يتفاعل مع أشخاص آخرين، وتُعرّف القيم أيضًا بأنّها عبارة عن أهداف الإنسان المرغوبة التي تكون فعّالة من خلال مواقفه، ومُرتبة بحسب أهميتها له، وتوجّه الإنسان نحو اختياراته، وتُقوّم سلوكه. ولكنّ الفلسفة الغربيّة أسبغت على هذه القيم إشكاليات جدليّة جعلت منها مجالاً للتضارب الأخلاقي بين الأمم.
[9] - السيد علي الحسيني الخامنئي، عناصر الثقافة، مرجع سابق، ص 55.
[10] - صموئيل فيليبس هنتنغتون (1927 – 2008) هو عالم وسياسي أميركي، وبروفسور في جامعة هارفارد لـ 58 عامًا، أكثر ما عُرف به على الصعيد العالمي كانت أطروحته بعنوان "صراع الحضارات"، والتي جادل فيها بأن صراعات ما بعد الحرب الباردة ستكون متمحورة بسبب الاختلاف الثقافي والديني بين الحضارات الكبرى في العالم. آخر كتبه صدر في العام 2004 وكان تحليلاً للهوية القومية الأميركية وحدّد ما عّده مخاطرًا تهدّد الثقافة والقيم التي قامت عليها الولايات المتحدة. وكان "هننغتون" مخططًا أمنيًا في إدارة الرئيس "جيمي كارتر"، وشارك في تأسيس مجلة "فورين بوليسي"، وترأسّ عدّة مراكز دراسات بحثيّة. وهو كان ديمقراطيًا وعمل مستشارًا لنائب الرئيس "ليندون جونسون"، "هوبرت همفري".
[11] - سورة الحجرات، الآية 13.
[12] - إدوارد سعيد، الثقافة والإمبرياليّة، من مقدّمة المترجم كمال أبو ديب، مرجع سابق، ص 12.
[13] - المرجع نفسه، ص 11.